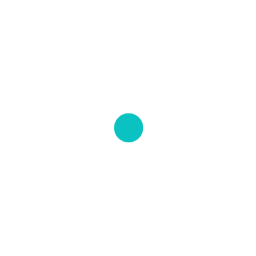
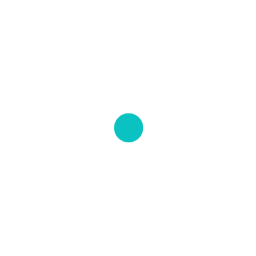
يعنى بالسرد القصصي والروائي
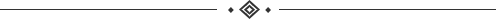


عبداللطيف الوراري || كاتب وناقد مغربي
كنتُ كأيُّها الناس، إلى أن قادَتْني يدايَ - لا أدري؛ أمصادفةً أم هِبةً من الله؟- إلى كتاب "ميزان الذهب في صناعة أشعار العرب" للسيد أحمد الهاشمي. كان -عندي- بمثابة كتاب مُقدّس. ظننْتُهُ في الأول كتابًا من كتب السحر والشعوذة التي كانت ذائعة بين أيدي الناس، وذلك لكثرة ما فيه من الجدول وأشكال الترميز والتقسيم والتقطيع، شبيهًا بـ"كتاب الدمياطي" الشهير الذي يثير الرعب بمجرّد ذكر اسمه بين السواد.
نعم، إنّه كتابُ سِحْرٍ، لكنّهُ سِحْرُ الشِّعر.
ظللتُ مع هذا الكتاب لوقْتٍ أَنْساني همَّ الوقت، أحفظ ما فيه من أبيات الشعر المنتقاة بعناية، وأجد ما فيها من القيم الرفيعة سلوى لي. وأتعلّم منه- بشيء من الحرص- قوانين العروض والقافية من خلال التمارين التي تتكرر في نهاية كل بحر شعري، ثُمّ فيما يتعلق منها بالقافية من حيث حروفها وعيوبها. أنفقْتُ ساعاتٍ أحاول ضبط الأوزان عن طريق تقطيع الأبيات عروضيًّا، وكنت أفعل ذلك بمنأى عن عيون الفضوليّين؛ فلو رآني أحدهم في ما أنا فيه من الأهوال والأحوال، لكان راعه منظري وأنا أتفصّدُ عرقًا وأتمتم بحروف غامضة لا تبين، كأنّي نبيٌّ يتلقى وَحْيًا من السماء ويتكتّمُ عليه.
سوّدْتُ أوراقًا كثيرة، وخططتُ خَرْبشاتٍ بِخطّي الغريب، وأنا أركض وراء الكلمات بشُبّاكي حتى تقع على التفاعيل بِـأيِّ معنى كان. ومُسمِّرًا عينيَّ في المعجم، أدوّن القوافي التي تنتهي بالحرف نفسه. قافية على إثر قافية مثل سِكّة حديدٍ بلا مسافرين.
كانت حدود وعيي بالشِّعر لا زالت غائمة ومضطربة، بموازاة مع طرق تدريس الأدب العقيمة وما يستتبعها من نزوع مدرسي يُشيِّئ القصيدة ويُسطِّح عمقها اللغوي والمجازي إلى حدٍّ فادح. مُعلَّقات، قصائد ومقطوعات شعرية كانت تمرُّ أمامي عيني بدون أن تُثير فيّ إِحْساسًا، ولا أن تحملني إلى مسافةٍ أخرى من الجمال والذوق. فقد كان مُدرّسو العربية يتأفّفون من الشعر، ويُكنّون عَداءً خفيًّا إزاءه. وحتى منهجيّة تدريسهم للنصوص الأدبية التي تغلب عليها الظروف التاريخية، وبالتالي تحجب ما فيها من صنعة وإبداع، لها يَدٌ طولى في الأمر. ولهذا، كانت حِصّة الشعر ثقيلةً ومُملّة وبلا معنى يُذكر. وهو ما جعل التلاميذ يُكنّون العداء للشعر، بل يُجاهرون به.
ولولا قدماي اللّتانِ ساقتاني إلى دواوين خارج الفصل الدراسي وإكراهاته، ولولا حاجة إلى تعويض كنْتُ أحِسُّها بداخلي، لَوجدْتُ نفسي بينهم ناقمًا على الشِّعر وأهله. قادَتْني خُطايَ إلى مكتبة هنا، ومكتبة هناك، فاقتنيْتُ دواوين من الشعر مما يدَّخر صاحبها منه: "رباعيات الخيام" بترجمة أحمد رامي، "الملاّح التائه" لعلي محمود طه، "الحياة الحب" لإبراهيم محمد نجا الذي أُعْجِبْت بقصائده الرومانسية والذات الأسيانة الشّفيفة التي تخترقها. كما تحايلْتُ على دواوين أخرى بإعارة أو إغارة، من مثل: "أغاني الحياة" لأبي القاسم الشابي، و"ديوان إيليا أبي ماضي"، و"ديوان بهاء الدين زهير" و"ديوان أبي تمام"، قبل أن يأتي ديوان "أحلى قصائدي" لنزار قباني ويقلب الطاولة.
كانت ساعاتي بين الدواوين الأولى ساعات حبّ وإصغاء وتعلُّم وصفاء.
وجدْتُني، في صيف ذلك العام؛ عام تسعة وثمانين، أنظم أول أبيات لقصيدة ممكنة أوقّعها باسمي. لا أذكر شيئًا عن القصيدة، لكن أتلمّس ضوء خربشاتها وراء دخان الأحلام، وأتلمّظ مذاقها البعيد على لساني؛ قد تكون نداءً على حبيب غائب، أو رَسْمًا لصورة مثال، ورُبّما كانت ضَرْبًا من وَهْم الذات الحالمة وَبَرْقًا في ساعة خلوة.
أقرأ، وأخطُّ كلماتي الجريحة مجازًا، وأُعاني من أجل التعبير عن دخائلي الدفينة بتمارين لغوية وإيقاعية كثيرة؛ بعضها مُتكلّف فيه، وبعضها صادقٌ لا يخلو من طرافة. ولهذا، قطعتُ مبكّرًا مع جريرة الإلهام التي كنت أجدها دارجةً عند بعضهم. وأذكر أنّه حين مات جدّي، استغللتُ سفر أُمّي إلى القرية فمددتُ يدي إلى الدخان وتنشّقْتُه بانتشاء، معتقدًا - كما توهمت من صور الأدباء وهم يحملون سجائر بين أصابعهم أو ينفثون دخانها بزهو في التلفزيون– بأنّه الطريق إلى الإبداع واستدرار ربّة الوحي. وتوافق ذلك مع ما كان في نفسي من ميل شديد إلى العزلة، ونفورٍ غير مفهوم من عامّة الناس، إذ كنتُ أختلي لساعاتٍ طويلة بذاتي إلى أن يجنَّ الليل، مُسْندًا ظهري إلى جذع شجرة الأوكاليبتوس في غابة على منحدر يغطس بأوراقه الصفراء في قناة صرف وسخة، أو مُكبًّا على مصطبة إحدى الحدائق العامة التي كانت تنعم بها المدينة قبل أن تزحف عليها الخرسانة وتُفوّتها لمتشردين وقطّاع أرزاق، وفي أحايين من صفاء النفس التي تخّففت من مؤونة المادة أشعر كأنّي في مقعد صدق مع الأشباح وحسن أولئك رفيقا.
لا أزال أذكر أن خطّي لغرابته وصغر حجمه أثار أنظار زملائي وأساتذتي وامتحن أفهامهم؛ فكانوا يتجشّمون العناء لقراءة ما أكتبه، وفكّ رموزه، وكأنّهم حقيقةً أمام طلاسم ورُقىً سحريّة، وليس أمام قصائد أولى لشاعر ناشئ كان يكتبُ ما يرِدُ عليه بارتعاش وامق وتوق غامض. وكانت الموسيقى شَرْطًا، تأتي من وادي النسيان وتجلس قريبًا منّي. أتسمّع موسيقى الطبيعة حينًا، وحينًا موسيقى الأغاني العربية الكلاسيكية من أساتيذها العظام، مثل محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وفيروز، وعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش، وعبد الوهاب الدكالي ونجاة الصغيرة. غير أنّ الأغنية التي هزّتْني بشكل لاواعٍ، لم تكن لهذا أو تلك، بل لمُغنٍّ مغمور أقلّ شهرة. ما إن تُردّد لازمة الأغنية: "طير يا طاير"، حتى أشعر بداخلي ينتفض. كنت لا أملُّ من سماعها، كأنّ تردادها ينادي عليّ للتحليق وقد ربّيّتُ أولى أجنحتي من دبيب الكلمات وفضائها، فأتخيّلُني ذلك الطائر الذي يقاوم بمخلبيه الصغيرين الأقفاص الحديديّة، ويهمُّ بالانطلاق إلى فضاء الله.
كانت أولى القصائد التي أخذتُ أكتبها تتوزّعُ بين شكلٍ عموديٍّ وآخر توشيحيٍّ، ولم أكن سمعتُ بشكل ثالث غيرهما، أو بالأحرى لم يلفت انتباهي إليه. وشاءت الظروف أن يتناهى إلى سمعي برنامج شعري يُذاع على أمواج الإذاعة الوطنية، وقد اشتهر مع الشاعر المغربي إدريس الجاي الذي أنشأه أوّل الامر، قبل أن يتولّاه بعد رحيله الشاعر وجيه فهمي صالح.
كان وجيه، مُعدّ البرنامج، فلسطينيَّ الأصل، اشتغل في بداية مساره الإعلامي بإذاعة الشرق الأقصى، ثُمّ جاء إلى المغرب واختصَّ بتقديم البرامج الفكرية والأدبية في الإذاعة. عُرف بوصفه شاعرًا غِنائيًّا كتب للأغنية المغربية أجمل القصائد الفصحى، وأشهرها القصيدة الوطنية "الفرحة الكبرى" التي لحنها الموسيقار أحمد البيضاوي وتألقت في أدائها الفنانة المصرية هدى سلطان، والقصيدة الرومانسية "ذكرى خلاصي" التي أدّاها أحمد البيضاوي نفسه بصوته الأجشّ الخافت.
سحرني وجيه بصوته العذب الرقراق أثناء تقديم البرنامج، وأكثر حين كان ينشد قصائد من شعره ومن شعر أشهر شعراء الرومانسية مثل إيليا أبي ماضي وبشارة الخوري. وما يزال هذان البيتان لأبي الماضي يتردّدان في أذني إلى اليوم:
أَيُّهذا الشّـــــاكي وما بِكَ داءٌ كيف تَغْدو إذا غدوْتَ عَلِيلا
إِنّ شَرَّ الجُناةِ في الأرْضِ نفْسٌ تتوقَّى قَبْل الرّحيلِ الرَّحيلا
سأقرأ لأبي ماضي كل أشعاره في هذه الفترة، ووجدت في صميمها ترياقًا لروحي وعزاءً لي عن حياةٍ لم أَخْترها. وكان هذا البيت وحده بمجرّد ما أُنْشده وأُدَنْدنه بيني وبين نفسي حتى يبعث فيها رجاءً عظيمًا:
الشُّجاعُ الشُّجاعُ عِنْديَ من أَمْـسَى يُغنّي والدّمْعُ في الأَجْفانِ أعترف بِدَيْنِ فهمي صلاح عليَّ؛ فهو أول أساتذتي الحقيقيين في بداياتي الشعرية، ومن شدّ أزري يوم كانت الرياح تعصف بي من كل جانب، مع أنّي لم أقرأ له كتابًا في الشِّعر إلا ذلك الكتاب الكبير الذي يفتحه أمامي ويُفتّح كل جارحةٍ داخلي لتقرأه معي.
فمنذ أن اتّصلْتُ بالبرنامج، وأخذتْ قصائدي الخطّية ترِدُ عليه بين عامي تسعة وثمانين وواحد وتسعين، لم يفتأ وجيه يُقدّمني على غيري ويثني عليّ ويضرب المثل بي في بروز الموهبة. مَثّل ذلك بالنسبة إلي حافزًا على المُضيّ قدُمًا في درب الكتابة وتطويرها؛ بل زادت ثقته بي حين اكتشفت أنّ أحدهم يسرق قصيدة من مجلة "الشعر" المصرية كان بحوزتي أحد أعدادها، وينسبها إلى نفسه. كتبت رسالة نقد لاذعة إلى الشاعر السارق، وضمّنتُها معنى واجب احترام الشعر وقُدْسيّته.
كان للإذاعة في تلك الأيام شأنٌ عظيم ونفوذٌ لا يُنازع، وكان البرنامج يُبثّ على أمواج الإذاعة الوطنية في وقت الذروة بين السادسة والسابعة مساء كُلّ ثلاثاء، فافتضح أمري بصفتي "شاعرًا" بين أصدقائي وأفراد عائلتي، وأنا الذي اعتبرْتُ الشعر حالة فرديّة خاصة يُكْتب بمنأى عن أعين النّاس وفضولهم، إلا أنّه في الحقيقة أشعرني بالزّهِو والتفرُّد.
أذكر وقتها أنّه في إحدى زياراتي للقرية خلال عطلة الصيف، وقد استحالت أطلالًا، اقترب مني عمِّي سعيد مُتوجّسًا، وأخبرني بأنّ أحدًا من أصحابه في السوق سمع بلقب "الوراري" يتردد في الإذاعة. ولمّا أخبرته بأن هناك برنامجًا أدبيًّا يذيع لي شعرًا أكتبه، لمحت أطياف الفرح على مُحيّاه، ثُمّ سرعان ما داخَلهُ الخوف إن كان الأمر يتعلّق بالسياسة أو بأمر جلل؛ فلم يكن العمُّ سمع قبل هذا الوقت بكلمة "شعر".
ولئن تبدّدت الكثير من قصائدي الأولى في دخان حياتي، فلن أنسى قصيدة "يا مُنْيتي" على مجزوء الكامل وقافية النون، التي سكبتُ فيها أنفاس هواي الجريح، ومنها هذا البيت الغريب على مجزوء الكامل، الذي يشرط ما قبله ويُورّط ما بعده:
يا مُنْيتي إنْ متُّ في يَوْمٍ وَهُزَّ النعشُ مَتْــنا
لما استمع إليها بعض أصحابي الظرفاء، اعتقدوا بأنّي نظَمْتُها تَغزُّلًا بفتاة كانت تدرس معنا في الثانوية نفسها، تُدعى "مُنْية"، وأنّي أريد بالقصيدة التودُّد إليها ومجاملتها. ذاع الأمر في الثانوية، وعلمت به الفتاة، ووجدْتُ حالتي بين خوف ورجاء. وحمدت الله أن النعش مرَّ بسلام، ولم يُعرض على المجلس التأديبي.
في إحدى الحلقات، سيفاجئنا وجيه برغبة إدارة الإذاعة بطبع دواويننا، نحن شعراءه الأكثر حضورًا. خاصمني النوم في تلك الليلة، وظلّت أطياف الحلم اللذيذ تُراقص مُخيِّلتي وتعبث بشعري المجعد القصير. أن يكون لي ديوانٌ مدبوغًا بِحرّ أنفاسي، وعليه صورتي واسمي إِسْوةً بالشعراء الحديثين الذين بدأْتُ أقرأ لهم وتشدُّني صورهم على أغلفة كتبهم، وأنا طالب في الثانوية دون العشرين من العمر، فيا لَلْحُلم ! يا لَلْهِبَة الربّانية !
ضممْتُ القصائد الجديدة والقصائد التي سبق أن قد أُذيعت في البرنامج بين دفّتي ديوان، وجعلت عنوانه ذا إيحاء رومانسي: "عرائس الصبا". حملت معي الديوان إلى الرباط التي عثرتُ على تذكرة السفر إليها بالكاد. ومن محطّة القامرة إلى شارع محمد الخامس، قطعتُ طريقًا طويلة ماشيًا، وجسدي تحت ثيابي يكاد يطير من ريح السيارات الفارهة التي تمرق مثل البرق، أو يتبدّد من حرِّ يَوْمٍ كالصراط (هل هو وهم الشّعر وعذابه الذي سأجنيه سنين عددًا فيما بعد؟). حين وصلتُ إلى الشارع الأشهر في العاصمة، سألتُ عن "سينما الملكي"، وقريبًا منها وجدت "مكتبة المعرفة" التي تعود ملكيّتها إلى وجيه. ما إن دلفت إليها حتى داخلتني رهبة المكان، ثُمّ واجهني رجلٌ طاعنٌ في السنّ يتوكأ على عصا وابتسامة ملائكية تُجلّل مُحيّاه. قدّمتُ إليه نفسي، فرحب بي أيَّما ترحاب، وقدّم إلي مَشْروبًا على عادة الكرم العربي الأصيل. وكان معه بعض شعراء التقليدية بجلابيبهم فقدّمهم إلي، وكان فيهم من كنت أقرأ له في مجلة "دعوة الحقّ"، أو شاهدت إحدى العرشيّات المتلفزة، مثل محمد بن محمد العلمي الذي نبغ في الشعر العمودي وله قصائد في الحكمة والمديح النبوي ومناجاة الله.
تَحدّث إلي وجيه كأب بلباقة ولطف، وأثنى على موهبتي، وأخبرني بأنّ مدير الإذاعة محمد طريشة معجبٌ بأشعاري. أودعتُهُ "عرائس الصبا"؛ حبّي الأوَّل، ومتاع ذاتي الشحيح، ودهشتي الأولى بالأشياء والعالم كما نثرتُها في قصائد وجدانية وعاطفية، منظومة بين شكلي العمود والمُوشّح. لكن هذا الديوان لم يكن إلّا حلمًا في الكرى، ولا أعرف أين هو الآن، فقد ضاع إلى الأبد، وضاع الذي كُنْتُه يومئذ من صورتي الحال والمحال !
ويكفي أنّي وجدت في برنامج "مع ناشئة الأدب"، سانحةً غالية وتَعْويضًا لا يتصوَّر عن واقع مُرّ لا يسمي الشعر ويتخاصم معه، إلا ما كان من شعر العرشيّات الذي كان يطالع به التلفزيون طوال يوم الثالث من مارس من كل عام، تاريخ جلوس الملك الحسن الثاني على عرش المغرب. وكان الشعراء في هذا الضرب من شعر المديح نَظّامين في أغلبهم. وهالني عددهم الذي يتجاوز المئات، وهم يهتفون بأمجاد المغرب في عهد الملك من الصباح حتى المساء، بِبِذْلاتٍ عصرية مع ربطات عنق أو بجلابيب تقليدية. وشدَّني من هؤلاء: محمد الحلوي بلغته الصافية وصوره الحسية، وأحمد عبد السلام البقالي بتراكيبه البسيطة وإيقاعه الراقص.
بيد أنَّ أوّل ما نُشر لي لم يكن من الشعر، بل كان قصة قصيرة استوحيتها من المجموعة القصصية "همس الحنون" للروائي نجيب محفوظ، وقد نُشرت في جريدة "السياسة" الكويتية في ربيع عام تسعين. كان حدثًا شخصيًّا من سجل التاريخ لا أنساه؛ إذ داخلني العجب بالنفس وأنا أجد اسمي جنبًا إلى جنب مع أدباء وشعراء معروفين، وتوهّمْتُ أن الناس الذين اصطّفت بهم كراسي المقاهي على أرصفة الشارع الرئيسي ينظرون إليّ بـﭑفتخار، بل منهم من يُحدِّث صاحبه بأنّ هذا هو "عبد اللطيف الوراري" الذي نشر القصة القصيرة هذا اليوم، مع أنّ هؤلاء بسحناتهم المُتغضِّنة كانوا في معظمهم فلّاحين مهاجرين وأصحاب موقف ينتظرون قوت يومهم في شغل طارئ، وندر أن ترمق بين أيديهم المُتعرِّقة التي تشققت أطرافها صحيفةً أو كتابًا ما.
وفي الجريدة نفسها نشرْتُ، بعد هذه القصة، نصّيْن أو ثلاثةً من الشعر الرومانسي الذي لم يكن يخلو من طرافة البدايات والمفاجآت غير السارّة للقافية، قبل أن تتوقف على إثر غزو العراق للكويت صيف ذلك العام الضاجّ بكلّ أخبار الدّم والعار ومُخاط الخيانات.
وكانت ثانوية موسى بن نصير التي يعود تاريخ بنائها بمعماره الكولونيالي الشاهق إلى سنة 1926، تحت اسم المدرسة الإسلامية، تقع في الطرف الآخر من المدينة؛ ولهذا كان عليّ أن أسلك طريقًا طويلة، وخلالها أسترقُ النظر لبعض المطبوعات التي كانت يعرضها أحد أكشاك الشارع الرئيس، أو أُتمتم بكلمات وأعاريض وعمليات حساب تأتي عليَّ بغتةً، كأني بهذا الترسيم الرياضي الشاقّ والممتع أقوّي خاطرتي وحافظتي في آن.
وكان ثمّة كثيرون من زملائي وسواهم قد وصلوا إلى هذه الثانوية، مُحْبطين وأكبر من سنِّهم؛ فمنهم من نَفَش شَعره وأدمن المخدّرات، أو تعلّق ببغيٍّ، أو أطلق لحيته وقصّب جلبابه، أو تهالك على مقعد الدرس قبل أن يُفْصل؛ فقد تمكّن اليأس من بعضهم، وبعضهم الآخر تَعرَّض لغسيل فكري من جماعات اليسار الراديكالي أو الإسلام السياسي أثناء صعوده، لأن الجامعة على الأبواب، والفصائل الإيديولوجية داخلها تحتاج إلى حطب يابس في المعركة المصيرية التي عليها "مستقبل الأمة في صراعها ضد الإمبريالية والرجعية".
وأذكر أنّ أحد زملائي في الفصل الدراسي، وكان سمت التديُّن باديًا عليه، أمدّني بكتابين لأحد زعماء الحركة الإسلامية بالمغرب لغاية مفيدة. وقد بقي الكتابان عندي لوقتٍ دون أن أستطيع قراءة أيٍّ منهما، فما شأني أنا بجعجعة مصطلحات "الإسلام السياسي"؛ فقد ملأ الشِّعر عليَّ سماء جديدة من حياتي ووجداني، فأرجعتهما إليه مع ما يوجبه الشكر وجميل العرفان. بل إنّه دعاني فيما بعد – كأنِّي به يجسُّ مفعول تأثُّري- إلى مجلس "إخوانيٍّ" بأحد دور الصفيح، وحضرت مع من حضر من شباب المدينة وفقرائها، فراعني ما وجدتُ فيه من امتثال وخنوع وفكر قطيعيّ، ورجعتُ ساخِطًا على نفسي ومُتودّدًا إلى الشعر ألّا أخرج ثانيةً على ميثاق شرفه وحياض مملكته السعيدة.
أخذتُ أتردّد بانتظام على مقرّ اليونسكو المقابل للثانوية، حيث تعرّفْتُ على الزجال الراحل محمد الراشق الذي كان يهندس أنشطته الثقافية ويُشْركني فيها، ثم على دار الشباب التي كانت تغلي بالعروض المسرحية والنقاشات السياسية، وفي هذه الدار شاركتُ في أول مهرجان أدبيٍّ وطني حضره ثُلّة من الأدباء الشباب الذي كان يشقُّ طريقه في القصة والشعر وقتئذٍ، ونظّمته جمعية المبدعين التي كان يرأسها سعيد عامل، وكرّمتْ خلاله الشاعر بنسالم الدمناتي أحد شعراء جيل الستينيّات في الشعر المغربي، الذي رجع لتوّه من مكناس وعمل مديرًا لإحدى مدارس المدينة، وما لبث أن أصدر ديوانيه "قُفّاز بلا يد" و "واحة النسيان".
كُنّا نتناوب على مِنصّة القراءات وفوق رؤوسنا تخفق يافطة كُتِب عليها بخطٍّ أحمر: "بمناسبة عيد العرش المجيد"؛ فإن أيَّ نشاط ثقافي لا يصحُّ أن ينعقد إلا بمباركة عمالة المدينة وتابعها المجلس البلدي الذي لا يجود بماله العامّ إلا في مناسبة وطنية وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أو في حملة انتخابية سابقة لأوانها. وعدا ذلك، فلا مكان للثقافة التي كانت تعني عند مسؤولي المدينة ما يُشْبه المعارضة السياسية الضمنية للقصر الملكي؛ لأنّ أغلب المثقفين كانوا ذوي توجُّهات يسارية راديكالية ويمكن أن تَتبيَّن بعض علائم سخطهم من نبرة خطابهم وشكل هندامهم المهمل وشعرهم المنفوش.
يا للمفارقة !
ففي وقتٍ كنت مُنْهمكًا في ترتيب أوضاع بيتي الرمزي، ومنفيًّا خارج واقع الناس، ومتفرّغًا لعالم آخر بدأ يُلحُّ علي، كانت أُمّي تُواجه حُكْمًا بالإفراغ من البيت الذي انتقلنا للسكن فيه بعد زواج الخال الأعزب من امرأة ريفيّة، إذ لم تجد ما تُؤدّيه من سومة الكراء.
ماذا بِوُسْع الشِّعر اللامرئي والمستكين إلى نفسه مثل بضاعة تالفة، أن يفعله لي ولغيري من حوائج السوق البشرية، حتى أردَّ عني الشرّ الوبيل لواقع مفترس لا يرحم، وتكاليف أعباء جديدة في الطريق .