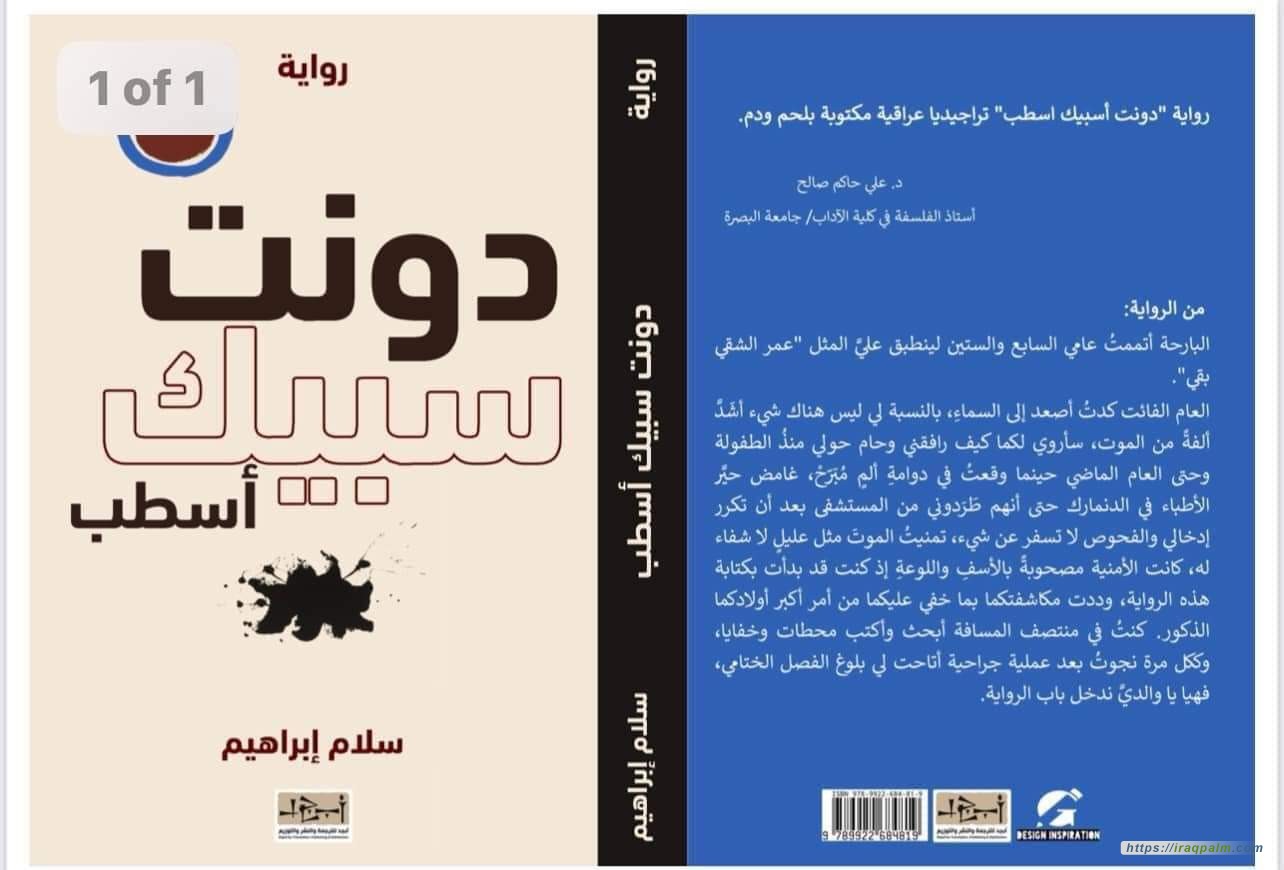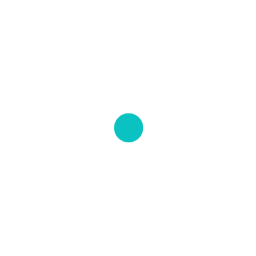
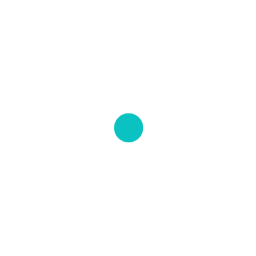
يعنى بالسرد القصصي والروائي
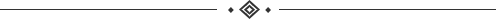

سلام إبراهيم | قاص وروائي عراقي
لم أنم ليلتها، أرقتُ، متقلباً في فراشي مثل سمكةٍ على اليابسةِ، متوتراً، قلقاً، مختنقاً. نهضتُ جالساً وأرهفتُ السمعَ في سكونِ البيتِ الكبيرِ، ليس غير دوي رأسي المشتعل، بما واجهت من أقرب أختٍ ليَّ، فقد كنتُ أعيش بينهم أشهراً منذ صباي، تسللتُ على أطرافِ أصابعي وفتحتُ الباب المفضي إلى الحديقةِ الواسعةِ لأنزوي على الكرسي نفسه جوار السياج أنفثُ دخانَ سجائري التي أشعلها الواحدة من الأخرى، وأرمي بصري في السماء خفيضة النجوم تارةً، وفي مصابيحِ الشارعِ المتدلية تارةً، ضاقتْ عليّ الدنيا، إلى أينَ ألجأ في مدينةٍ ضيقةٍ كالديوانيةِ؟، فمن المستحيل النزول في فنادقها الرثةِ ولديَّ عدد لا يحصى من بيوتِ الأقاربِ، ثم أن ذلك سيعتبر عاراً ما بعدهُ عار على عائلتي، كانَ الضيقُ يزداد شداً عليّ وأنا أستعرض وجوه أخواتي المتزوجات المتمكنات، فتأثير أمي القوية الصلبة كاسحٌ عليهنَّ، أدرك ذلك، فمجرد كلمة أو إشارة منها تُغلَق الأبواب في وجهي مثلما فعلت أختي الأقرب قبل ساعتين، كان حصاراً اجتماعياً لم أشعر بمثيلٍ لهُ حتى في زنازينِ الاعتقالِ، ففيها لا حول لك ولا قوة، فقط يتطلب منك الصبر وتحمل ألم التعذيب، وحبس الكلام فتنجو، كنتُ أدرك ذلك، فعلتهُ ونجوت، لكنني محاصرٌ من أحبابٍ شديدَ التعلقِ بهم، أعوم في فضاءٍ لا مرسى له. جعلت أتمشى من شّدة الحيرة، أنفثُ الدخانَ وزفير الغضب نادماً لتسرعي في حزم أمتعتي ومغادرة البيت، أنهكني التفكير وانسداد السبل، فتهالكت على كرسيي مسترخياً، متكئاً برأسي على حافتهِ مبحراً بين مصابيح السماء الكثيفة الغامزة في وجودها المبهم، أغمضتُ عينيَّ المتوترتين وسكنتُ في نقطةِ التلاشي التي ينمحي فيها الموضوع، فيغيب الأمس والغد وتتجلى اللحظة الحاضرة والمستمرة فقط، وفيما أنا في العمقِ ذاك رأيتُ وجه أصغر أعمامي "عيسى" ناصعاً ضاحكاً يقف وسط سوق المدينة المكتظ وينادي عليّ:
- سلام.. سلام صار لي ساعةْ أَصَيّحْ!
أختلطَ مشهدُ مناداته بصوتِ آذان الفجر الذي أيقظني من حلمِ يقظتي مسروراً بباب الفرج المفتوح على عمي "عيسى" أفقر أعمامي، وأقربهم إلى اسمه فهو فعلا قريب جدا إلى ابن الله، عامل نجارة كادح، كانَ نحيلاً معلولاً يكسبُ قوتَ يومهِ بعناء، تزوجَ من بنت عمه وكوّنَ أسرةً عانتْ شظفَ العيشِ، منحتهُ البلدية بيتاً في "حي الفقراء" بطرف الديوانية الجنوبي، وحينما أعجزه المرض تماماً وبات يصعب عليه السير دون عصا واستراحات، خصصَ لهُ والدي راتباً شهرياً يقتطعهُ من مرتبة البسيط، وحدثني عنه صديقي الشاعر عزيز السماوي، قائلا:
- عمك "عيسى" من أشهر هتافي تظاهرات اليسار العراقي زمن الملكية!
ورسمَ لهُ صورةً ساطعةً، من اللحظةِ التي يُحْمَل فيها على الأكتافِ فيرتجل أهازيج تهزئ من الحكوماتِ العميلةِ، وعن قدرتهِ على ترتيبِ كلمات أهازيجه الحماسية بدقةٍ وعفويةٍ، وعن قوةِ صوتهِ الجهوري الذي يشعل حماسَ المتظاهرينَ إلى أقصاه.
في الصبيحةِ التاليةِ حملتُ حقيبتي، وغادرتُ إلى بيتِ "عمي". أستقبلني بعناقٍ حارٍ، ودونَ مقدمات قلت:
- عمي جاي أسكن عِدكُمْ!
لا أستطيع وَصف مبلغ سروره، أشرقَ وجهه، وأبرقتْ عيناه، وعاودَ حضني مردداً:
- صدگ عمي وراح يوميه أشوفك.
لم يسألني عن الأسباب، كانَ يُفكر بقلبهِ لا عقلهِ والحياة قصيرة، عبرَّ عن ذلكَ بجملتهِ العفويةِ كونهُ سيفوز برؤيتي، وهو الذي سيموتْ وأنا في منفاي، وسأقف على قبره بعد عودتي في سرداب عائلتي جوار أمي وأبي وأكلمهُ بحنانٍ. لم يسأل لكنني في الأيام التالية أخبرتهُ عن السببِ وأردتُ أن أشرحَ لهُ التداخلات التي أدتْ إلى المأزقِ، فقاطعني قائلا:
- عمي لا تدوخني، الزبدة!
انفجرتُ في ضحكةٍ عاصفةٍ تحت نظراتهِ الحادةِ الذكيةِ التي سخرتْ من ثرثرةِ مثقفٍ يحلمُ بالكتابةِ، ضحكتُ من نفسي وشرحي، وأضحكُ الآن لحظة الكتابة بعد قرابة أربعين عاماً من تلك الأحداث، ما أدق وأعمق البساطة والوضوح، سحرني بجملته، فقلت:
- عمي أني أحب وحده وأريد أزوجها وأهلي سووا عليّ ثورة!
- معقول أش بيهم مخابيل، أسمع عمي تبقى عندي وقل لها خلي تزورك هنا! ولا يهمك عمي معقولة أخوي (يقصد "عبد سوادي") ضد الحب، معقول!
نزلتُ إلى سوقِ المدينةِ، واشتريتُ فراشاً وأغطيةً، كم شعرتُ بالذنبِ لإهمالي زيارته، عميّ العاجز الفقير المسكين الذي بات مع تقدم العمر لا يستطيع مغادرة بيته والتجوال في السوق أو زيارة أحد، شعرتُ باحتقارٍ شديدٍ لنفسي وأنا الماركسي المتحمس للكادحين والمساواة والعدالة والثورة، المشغول في قراءةِ الكتبِ والجدل في المقاهي، والوسط الأدبي، أنا الثوري أو هكذا كنت أعتقد لم أفكر لحظةً بزيارةِ بيت عمي الفقير والإحساس من جديد بمعنى الفقر، أي تجربة عشتها في ذلك البيت الفقير الذي تحس أن جدران غرفه من ورقٍ على وشكِ أن تتهدم، أي تجربة ساحرة وكأنها حلمٍ أكسبني عمقاً فاقَ تجارب الاعتقال والجدل والعمل السري في التنظيمات، غرفٍ متداخلةٍ، وأرواحٍ متداخلةٍ، لم أعِش أروعَ من تلكَ الأيام وصبية عمري واصلتني كنا نختلي في غرفة متطرفة ونغرق في بحرٍ من العناق والقبل، والأحاديث المهموسة أيام كأنها أحلام، وكان عمي وزوجته وأبنائه سعداء بنا، أحبوها لم يسأل أحدٌ من تكون؟.. هي حبيبة "سلام" وكفى!
أية ليالي ضاجه بحكايات وقصص نسفر بها، رويت له عن حادث جرى له في تظاهرةٍ من التظاهرات في مطلع الخمسينيات، في وقت قَوَتْ السلطة فيه وهان عزم المتظاهرين قليلا، رفعه أربعة رجالٍ أشداء على الأكتاف فأشعل حماس المتظاهرين وجذب من كان على الرصيف بهتافاته العفوية المبتكرة عن المساواة ومعاداة الاستعمار والعمالة، وحينما بلغت التظاهرة ساحة المتصرفية جوار النهر مقر الحكومة وقتها، هجمتْ فصائل من شرطة المشاة والخيالة المدججين بالسلاحِ والتي أطلقت النيران فوق رؤوس المتجمهرين فتفرقوا هاربين في شوارعٍ فرعيةٍ، فوجدتَ نفسك يا عمي وحيداً محمولاً من أربعة رجال لا تعرفهم، ورفاقك هربوا ناجين بجلودهم، صرختَ بهم:
- رفاق نزلوني أجو الشرطة!
فضحكوا قائلين:
- ومنو ينزلكْ ولكْ دَمَرتْ العالمْ بهتافاتكْ!
وحملك الرجال الأربعة إلى دائرة الأمن، إذ تبين أنهم من شرطة سرية. وهذا المشهد ذروة النكتة التي يرويها "عزيز السماوي"!،
ليلتها كنتُ أسهر جالساً على فراشه المبسوط على حصيرة قديمة بطرف الغرفة، انفجر ضاحكاً بصخب مردداً:
- هاي أش ذكرك بيها!
و أكد صحتها وروى ليّ مرارة تلك التجربة، وأسهب بالتفاصيل؛ كيف حملوه إلى داخل المتصرفية، وكيف أذاقوه الذل والهوان وهو المسكين الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه عاشق لفكرة المساواة.
- عمي سلام شِفِتْ الويلْ بس ما تنازلتْ!
ما أسعد تلك الأيام في بيتِ عمي الفقير.
لا أحد يسألني عن شيء، متى عدت، متى خرجت، أين كنت، بيتٌ فقير أنساني أهلي وخلاني وصبيتي تزورني ونمارس حريتنا في المحبة والشوق دون رقيب.